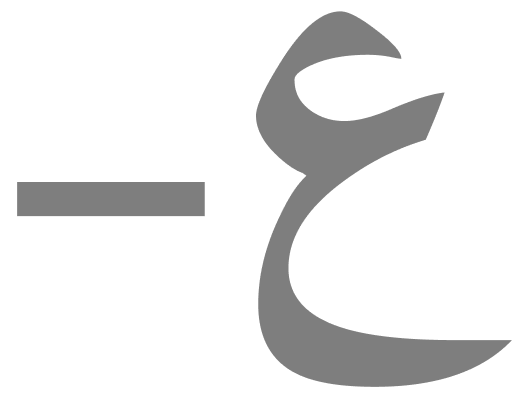أنجيلا ميركل، التي تشغل منصب المستشارة منذ 2005 ولكنها تنوي الاعتزال بعد الانتخابات الوطنية الألمانية المقررة في 26 سبتمبر المقبل، قامت بزيارة إلى واشنطن الخميس من أجل لقاء وداعي مع الرئيس جو بايدن – وربما وداع عاطفي لليبراليين أميركيين كثيرين كانوا يعتبرونها، وخاصة خلال رئاسة دونالد ترامب، «مدافعة عن الديمقراطية والكرامة الإنسانية ظلت متشبثة بقناعاتها».
ترشحت ميركل لمنصب المستشارة أول مرة في 2005 ببرنامج يَعد بالتحرير الاقتصادي وخفض الضرائب، فرأى فيها المحافظون الأميركيون «مارغريت تاتشر جديدة». ولكن ذاك البرنامج الاقتصادي سرعان ما تلاشى واختفى بعد تسلمها منصب المستشارة في ائتلاف برلماني مع «الديمقراطيين الاجتماعيين» الذين يجنحون إلى اليسار.
وبدلاً من ذلك، اتبعت ميركل سياسة تقليدية تتوخى موازنة الميزانية، داخلياً وخارجياً، حيث فرضتها على دول جنوب أوروبا المثقلة بالديون – رغم شكاواها وشكاوى واشنطن – مقابل المساعدة الألمانية خلال الأزمات المالية العالمية.
وفي 2010، وعدت ميركل بالتراجع عن تعهد حكومي سابق بالإنهاء التدريجي للطاقة النووية – لتغيّر موقفها بشكل جذري بعد أن تسبب الحادث النووي في محطة فوكوشيما اليابانية في مارس 2011 في حملة مناهضة للطاقة النووية بشدة في ألمانيا. فاضطرت ألمانيا مؤقتاً لإحراق فحم أكثر، وهو أحد الأسباب التي تفسّر انخفاض حصة الفرد من انبعاثات الكربون في ألمانيا ببطء أكبر خلال فترة حكم ميركل مقارنة مع الولايات المتحدة.
وبعد أن قالت في 2010 إن التعددية الثقافية «فشلت فشلا كليا»، وافقت ميركل خلال صيف 2015 على استقبال مليون لاجئ فار من حروب الشرق الأوسط، عوضاً عن تحمل مسؤولية منعهم من الدخول.
وكان ذلك القرار الأكثر جرأة – والأخطر سياسياً. وفي 2016، وبينما كانت ألمانيا تعاني من مشكلة الهجرة، وكان حزب من اليمين المتطرف المناوئ للمهاجرين يتقوى، عمدت ميركل، من خلال الاتحاد الأوروبي، إلى دفع مليارات الدولارات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أجل وقف تدفق المهاجرين واللاجئين.
وربما تستطيع ميركل أن تحاجج بأن كل هذه الحلقات عرفت نهايات سعيدة. فالعملة الأوروبية المشتركة بقيت، وخفض انبعاثات الكربون الألمانية تسارع، وإدماج المهاجرين يتحسن، والدعم الشعبي لأحزاب اليمين المتطرف استقر في نحو 10 في المئة.غير أن الآفاق تبدو أكثر قتامة بخصوص العلاقات الألمانية مع الولايات المتحدة. والحق أن ميركل سياسيةٌ مؤيدة لواشنطن بشكل عام، نشأت في ألمانيا الشرقية تحت حكم نظام شيوعي تمقته ويخضع لهيمنة روسيا. غير أنها وجدت نفسها تقول، بعد أن اصطدم ترامب معها ومع أوروبيين آخرين في قمة مجموعة السبع في 2017، إن الأيام التي كان يمكن فيها لأوروبا «أن تعتمد بشكل كلي على آخرين قد ولّت إلى حد ما».
وقد كانت تعبّر عن شعور متنام – يستند للأسف إلى الواقع – بأن المشهد السياسي الأميركي قد دخل وضعاً جديداً غير مستقر. شعور استمر حتى بعد رحيل ترامب. فبالنسبة لكثير من الألمان، الذين تأثروا كثيراً بسوء تعاطي الولايات المتحدة مع حربي العراق وأفغانستان حتى قبل ترامب، فإن التحالف العابر للأطلسي الذي كان قائماً في الماضي على القيم والمصالح المشتركة بات الآن رهينة تحولات حزبية بين الإدارات «الجمهورية» و«الديمقراطية».
ويُظهر استطلاع جديد للآراء أُجري لحساب «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» أن 39 في المئة من الألمان يعتبرون الولايات المتحدة «شريكاً ضرورياً... يجب علينا استراتيجياً التعاون معها»، مقابل 19 في المئة ينظرون إليها باعتبارها «حليفاً». (وفي الأثناء، يرى 22 في المئة من الألمان الولايات المتحدة إما «منافساً» أو «خصماً»).
وتبعا لذلك، اختارت برلين توزيع رهاناتها الاستراتيجية، فرفضت أن تتخلى عن خط أنابيب غاز مربح مع روسيا فلاديمير بوتين، وسعت وراء اتفاق حول الاستثمارات مع الصين، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحتى أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
والحق أن ميركل استغلت القوة الناعمة لبلدها أحسن استغلال – قوتها المالية ومكانتها الديمقراطية – ولكن نظراً لخضوعها للرأي العام الألماني شبه المسالم واحتمائها بمظلة منظمة حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، لم تفعل شيئاً لدعم القوة الصلبة الألمانية من خلال زيادة الإنفاق العسكري.
ولكن إلى متى سيستطيع بايدن والرؤساء الأميركيون المقبلون الاستمرار في تحمل ذلك والتسامح معه، من دون الإساءة للناخبين في الولايات المتحدة؟ هذا سؤال مهم يبدو أن ميركل سعيدة جداً بتركه لمن سيخلفها للتعاطي معه.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلوميبرج نيوز سيرفس»